.jpg)
في اليوم الأول من كل عام ، تلقي الشمس بنورها على الدنيا لتنير العالم بعام جديد
و تهدي إلى إبني سنة جديدة من عمره
فمع شروق تلك الشمس هذا العام ، يكون لدى إبني في تاريخه
شتائين
و فطام
و ساقين يطلقهما للريح كلما إستطاع أن يهرب من رقابتنا
وآلاف من نزلات البرد
وصديق
وحجرة
وجواز سفر عليه صورته و تأشيرتين وعده أختام
ولسان ، نُسجت عليه عشرات الكلمات و عدة عبارات واضحة النطق و المدلول
عامان هما كل تاريخه
رغم إحساسي الذي يؤكد أنني أعيش مع هذا الطفل منذ كنت أنا طفلاً
فكم هو رائع أن تكون أب لطفل له مثل هذا القلب ، أو الحنان
كم تساوي تلك اللحظة
عندما تحتضنه بين ذراعيك
لتجد كفه الصغير الحاني ، يربت على كتفك فيزيح عنك أوجاع الدنيا
ويحيل عمرك إلى وادي من الدفء ، و السعادة .
إن مشاعر الأبوه بالفعل تختلف جدا عن مشاعر الأمومة
فالأم تقع في حب وليدها قبل أن يولد
تعرفه
و تتفاعل معه وهو مازال جنين في ظلمات ثلاث
بينما الأب
يحتاج إلى تاريخ وعمر ، وأحداث
وكلما مر يوم يزداد حبه لأبنه أكثر
وتضرب جزور الإبن في قلب الأب
لتنبت شجرة من المحبه و الألفه و التوحد
هكذا يكون " إلّي خلّف ماماتش "
ويشعر الأب بالفخر كلما وجد تشابهاً بين ما يفعله إبنه وما يفعله هو
والسر في هذا هو الإمتداد
فالأم لا تشعر بحاجتها أن يكون لها إمتداد
حيث أنها إعتادت كأنثى ، وقبلت كزوجة ، أن تنتمي لشخص آخر
بينما الأب
يشعر بحاجة ماسة جداً لأن يكون له من يخلفه
ويحي ذكراه
ويكمل مسيرته من بعده
ويكون له سند و ظهر و عزوه
حتى لا تنقطع سيرته من هذة الدنيا إلى الأبد
واليوم ، وأنا أرى إبني ، يكبر يوما بعد يوم
وعاما بعد آخر
لا تكاد الدنيا تسعني من السعادة
ولا تكاد الغات
كل اللغات
قادرة على أن تصف ما يختلج صدري من إمتنان لله سبحانه و تعالى
أن منحني طفل جميل ، طيب ، معافى .
إلى عمر ،،
يا أروع طفل في هذا الكوكب ، أحمد الله على منحي نعمته التي هي أنت ، و أشكر لك كل ما تمنحني إيّاه من مشاعر و سعادة ، وإمتداد بإذن الله تعالى ، وكل عام وأنت بأفضل صحة و حال .
إلى زوجتي ،،
لم أكن أفكّر وأنا أختارك لتكوني شريكة عمري ، أنني أنفذ وصية الرسول الكريم كما يجب أن تُنَفذ ، عندما قال صلى الله عليه وسلم " تخيروا لنطفكم " ، فأنتي خير زوجة وخير أم ، وأنتي بالفعل، هدية الله لي ، كما أحب أن أصفك دائماً
كل عام وأنتي حبيبتي
كل عام و عمر أكبر و أجمل










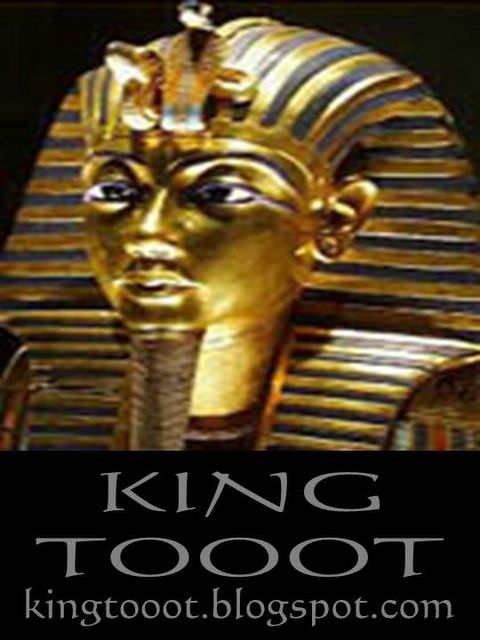














.jpg)






