
كانت تداعب سلسلة المفاتيح الطويلة بيدها في ملل واضح ، عيناها تنظر إلى الطريق وهو يطوى تحت عجلات السيارة الفارهة التي إشتراها زوجها منذ بضعة أيام ، سيارة كبيرة من نوع الجيب التي تكرهه ، لكن زوجها يهوى هذا النوع و كان يتطلع إليه دائماً ، وها هو الآن يمتلك واحدة من تلك السيارات التي طالما كان يحلم بها ، هي لاتعرف مايستهويه في هذا النوع الفاره المخيف ، سيارة لا يمكن أن تشعرك بالحميمية أو الألفه ، كما أن بها الكثير من النزعات العنصرية و التعالي ، فقط جهاز التكييف بها جيد ، هو الشيء الوحيد المحبب لها في هذة السيارة ، إنحنت برأسها للخلف ، لتلامس مخدع كرسي السيارة الوثير ، غاصت برقبتها في بطانته المريحة ، المريحة بدنياً ، إرتكزت برأسها المائل لتسطدم نظرتها بالزجاج المغلق معتم اللون ، كم كرهت هذا اللون المعتم ، صحيح أنه يمنع من في الخارج أن يرى من في داخل السيارة ، لكنه يشعر من بالداخل أنه في سجن حقيقي ، يأسره داخل حدود السيارة الديقة مهما رحبت ، ويحيله إلى جزء من غيام كئيب .
هاقد وصلنا ، قالها زوجها بإرتياح وسعادة ، مدخل الفندق الضخم ، التي نزلت فيه هي وزوجها عشرات المرات ، هو ذاته الفندق الذي شهد ايام شهر العسل ، وهو ذاته الفندق الذي ذبحت فيه عذريتها بطريقة لم تنساها أبداً يوما ما ، إقتنص يومها حقه إقتناصاً ، ونام ، لم يتألم لبكائها ، أو إنكسار مشاعرها تحت وطأت هجمته الشرسة ، فقط تألم عندما إستضم معصمه بطرف المنضدة ، هذا ما كان يؤلمه في تلك الليلة ، مر على تلك الواقعة عشر سنوات ، أثمرت عن عمر من التعاسة و طفلين وسيارة جيب ، ورحلة تمقتها إلى مكان تمقته ، طالما كان لديها الدافع و الإستعداد لتغفر و تصفح و تسامح وتنسى وتعيد عقارب الزمن للوراء عشر سنوات ، فقط إذا قال لها كلمة رقيقة ، أو أهداها وردة ،أو إعتذر لها يوما عن ذنب تافه يكون قد أقترفه في حقها ، لكنه لم يفعل . . أبداً لم يفعل .
إستدارت تلملم باقي أغراضها قبل أن تغادر الغرفة ، عوامات الأولاد ، كريم الشمس ، كارنيهات المناشف لتستبدلهم على الشاطيء ، رواية لإحسان عبد القدوس تقرأها للمرة السابعة عشر ، الجرائد لرب الأسرة ، وضعت كل الأشياء في شنطة صغيرة من نوع "الهاندباج " و مشت ورائه و أبنائها كالتعجة في القطيع ، هي طبعاً آخر القطيع ، كم تمنت أن يحمل عنها تلك الشنطة ، أو حتى يعرض عليها حملها ، لم يفعل بالطبع ، نزلت الدرج المؤدي إلى باب الخروج للشاطيء ، فتح الباب ليعبر هو أولا ً ، ثم الأبن الأصغر ، فالأكبر ، ترك الباب ليغلق من تلقاء نفسه ، سندت الباب بظهر معصمها التي تحمل به الشنطة ، و أكملت بذراعها الضعيفة فتحه وهي تلملم طرف ثوبها كي تمنع الرمال أن تعلق به ، رأت البحر ، كانت لم تراه حتى تلك اللحظة ، تمنت أن ترتمي في أحضان البحر متدثرةً بضوء الشمس ، فاردةً ذراعيها عن آخرهم لتحتضن الكون .
إنتهت السهرة ليلا ، عائدة هي إلى الغرفة خلفه ، يفتح باب الغرفة تاركه لها لتغلقه ، يخلع ملابسه ويجذبها ، وكما جرت العادة بينهم طوال عشرة سنوات ، يقتحمها دون إذن أو هوادة ، لتشم هي رائحة عرقة الممتزج بالعطر الرجالي الثقيل ، تألمها ذقنه المنبته الخشنة ، يدايقها هذا السوار الفضي الذي يلتف حول معصمه ، تزعجها زفراته و أنفاسه ، ثم ينتهي كل شيء ، دون أن تشعر هي باي حميمية أو سعادة ، فقط هو سعيد ، يبتسم ويتنهد ، ويتجشأ و يرقد على ظهرة ، يطلب منها أن تغلق الضوء ، الذي يصر هو أن يكون مضائاً ليفقدها أي شعور برومانسية تلك اللحظات ، تطفيء نور الأباجورة ، تتقوس على ذاتها في وضع جنيني، و تبكي، أو على وجه الدقة تنتحب ، فيمتزج صوت نحيبها مع صوت"شخيره"العالي لتستيقظ صباحاً فتجده مازال نائماً ، تنظر إلى جسده الضخم الراقد في ثبات ، تحاول إيقاظة ، تناديه بإسمه ، تهزه ، تنهره ، تلطمه على خديه ، دون جدوى ، تعرف يقيناً أنه قد مات ، تبكي ، تنهمر دموعها إنهماراً ، تجلس على حافة السرير ، لترى صورتها في مرآة التسريحة ، وجه ممتقع ، وعينان مبللتان بالدموع الكثيفة ، وأنف مرتشح ، ولكنها مع هذا تلمح شبح أبتسامة فوق شفتيها ، إبتسامة رضا وإرتياح .





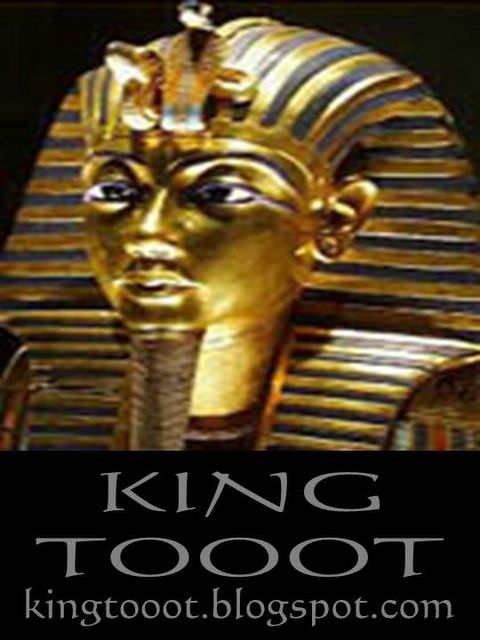
















.jpg)






